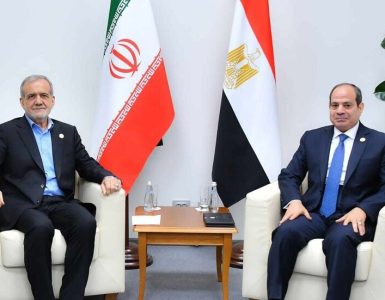انهارت ثورة يناير في مصر لأسباب عديدة، بعض هذه الأسباب متعلقة بببنية السلطة ودور الجيش في الحياة السياسية، والبعض الآخر ناجم عن الأخطاء التي ارتكبتها القوى الجديدة في إدارة الصراع في مرحلة بعد الثورة، اذ عجزت هذه القوى عن حل خلافاتها الايديولوجية والسياسية ومن ثم إقامة تحالفات قوية للحد من هيمنة الجيش وتقييد نفوذه. في الوقت الذي استنفد فيه المعسكر المؤيد للثورة جل طاقته في التناحر وتبادل التهم، عملت الآليات المضادة للثورة، مدعومة بأموال بعض دول الخليج الحاقدة على الثورة، على تحويل حياة المصريين العاديين إلى بؤس دائم متعاظم ومن خلال الفوضى المصطنعة، والتلاعب بأسعار الوقود والغذاء، وإعاقة عمل الحكومة عن طريق البيروقراطية القديمة في القضاء والإدارة وجهاز الاستخبارات، وإعلام يسيطر عليه المجلس العسكري وجيوب المصالح المرتبطة به، أضحى المصريون موقنين بأن بلدهم يترنح على حافة الانهيار.
وهكذا جاء الخلاص فجأة ممثلاً بشخص الجنرال السيسي، في واحدة من أحلك المفارقات في التاريخ، قلبت فيها الحقائق راسا على عقب وجرّدت المفردات من معناها. مع اغتصاب السلطة، تم اغتصاب الرموز أيضاً، فميدان التحرير، الذي كان شعاراً للثورة الشعبية ضد الاستبداد، تحول إلى مسرح ضخم يحتفى فيه بعودة النظام القديم في أجواء كرنفالية صاخبة محكمة الإخراج. الانقلاب العسكري الوحشي غدا “حركة تصحيحية”، والثورة المضادة “ثورة 30 يونيو المجيدة”، كما أن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطياً من طرف غالبية الشعب، أضحى دفاعاً عن الديمقراطية وتجسيداً لإرادة الشعب.
منذ البداية، تم تصوير السيسي كوزير دفاع متفانٍ هب بنبل لتلبية نداء الواجب الوطني وابتغاءاً لمصلحة مصر لا غير، خادماً للشعب، يركع صاغراً أمام الإرادة الشعبية، واستندت شرعيته على التفويض المباشر من الشعب الذي يتوق للخلاص والنظام والاستقراربعد جحيم الفوضى، تلك هي “مسؤوليته التاريخية”، وأضاف قائلا “سنبني مجتمعاً مصرياً قوياً ومستقراً، لن يستبعد أي شخص من أبنائه”.
بعد عامين من هذا الخطاب المتلفز، تبدو مصر أبعد ما تكون عن جنة الاستقرار والتماسك الموعودة هذه. مئات المصريين قضووا على يد شرطة وأجهزة أمنية تزداد شراسة يوما بعد يوما، وآخرون حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات صورية هزلية، بينما يقبع عشرات الآلاف في السجن في ظروف وحشية يمارس فيها التعذيب بشكل منهجي وروتيني. آلة القمع التي كان الإخوان أولى ضحاياها سرعان ما أتت على المعارضين من كل صنف فغاب كل هامش للحرية والتعبير وغدا دور الإعلام والصحافة منحصرا في تلميع صورة الجنرال الحاكم وتعداد مناقبه وترداد أقواله وخطاباته بشكل ببغائي فج.
الحكم الاستبدادي للسيسي لم يتمخض عن الاستقرار السياسي الموعود ، فبين التمرد المتسع في سيناء والهجمات القاتلة في العاصمة نفسها والصراع السياسي المفتوح وحكم الطوارئ المتواصل لا يبدو سجل سيسي الامني بأفضل من سجله الديمقراطي كالح السواد.
هل من الغريب بعد ذلك إذن أن تبدو مراكز الاقتراع مهجورة عن بكرة أبيها على مدى الانتخابات البرلمانية المصرية؟
فيما وصفه المراقبون على أنه “انتخابات دون ناخبين”، كان الإقبال منخفضاً لدرجة وصلت معها نسبة المصوتين إلى ما لا يتجاوز الـ3% في بعض مراكز الإقتراع، ففي حركة معارضة جماعية صامتة، تحدى الشعب المصري بروباغندا الدولة التي تراوحت بين التوسلات العاطفية والنداءات الحارة لتحفيز المشاعر القومية واللعب على العقيدة الدينية، إلى التهديدات المبطنة والمفتوحة لتغريم الممتنعين وإدانتهم بتهمة الخيانة. المصريون رفضوا ببساطة أن يكونوا جزءاً من المهزلة التي تهدف إلى إلباس السيسي رداءا ديمقراطيا لا يزال يحتاجه بشدة عله يمحو به وصمة انقلابه العسكري المغمس بالدم.
عجزت القوى الجديدة التي صعدت فجأة إلى مقاليد السلطة في أعقاب الثورة، دون إقامة تحالفات عن تجاوز العقبات القوية التي وضعت في طريقها، لكن قوى والثورة المضادة التي يقودها الجيش تواجه اليوم أزمة عميقة أيضاً. فرغم كل القمع والاضطهاد، أخفق الحرس القديم في صياغة المشهد المصري على النحو الذي يراه مناسباً أو في إملاء مسار الأحداث،فالاحتجاجات على حكمهم مسمرة ومطردة، وباتت تأخذ أشكالا مختلفة من المفتوح إلى الصامت، من المظاهرات الأسبوعية في أجزاء مختلفة من البلاد، إلى امتناع الناخبين عن الاقتراع بشكل جماعي.
عاجلاً أم آجلاً، سيدرك السيسي بلا شك بأن وصفته السحرية المؤلفة من القمع والتخدير الشامل للشعب من خلال وسائل الإعلام والدعاية الدينية، لن تحوله إلى جمال عبد الناصرجديد، فأوهام العظمة التي تستبد به لا تغير من حقيقته شيئا، ومن كونه ليس بطلاً ولا منقذاً وطنياً، بل مغامر عسكري متهور، وزعيم لثورة مضادة قد تدوم بضع أعوام، لكنها لن تعمر طويلا.