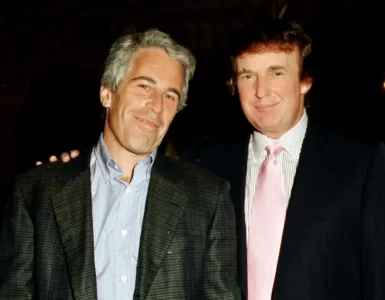عند منتصف ليل القاهرة، أطلق شقيق المعتقل السياسي، المختفي قسرياً، إسلام خليل، صرخةً أخيرة لإنقاذ شقيقه “الذي يموت الآن تعذيباً في أقبية الأمن”، بينما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تنتحب على الرحيل المفجع لطالب الطب، أحمد مدحت، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه، ثم اتصلت بأهله، بعد أقل من ثلاث ساعات لاستلام الجثة.
الشاب إسلام خليل، الذي تعرّض لأبشع التنكيل والتعذيب والإهانة منذ اعتقاله، وحتى ما بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله، كان بينه وبين مصير طالب الطب، أحمد مدحت، لحظات معدودات، لولا أن قبيلة الحقوقيين تجمعت عن بكرة أبيها على “السوشيال ميديا”، وخاضت معركة ضروساً لإنقاذه.
هذا جيد وإنساني ونبيل، لكنه يظل فعلاً ناقصا، وحركة فئوية في إطار ضيق، تستهدف إنقاذ حياة أفراد، لا مجموعات، وتكشف الوقائع أنه، في حمأة النضال الحقوقي المشتعل لتحرير معتقلين معروفين، يسقط آخرون، ضحايا المقتلة الأمنية، ممن لا يعرفهم الناس، مثل سائق السيارة الفقير على الطريق الدائري، وطالب طب عين شمس، ولا يدوّن من أجلهم أحد، أو يضغط على جثة هامدة، اسمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكي تسترد الحياة، مؤقتاً، لإنقاذ ناشط، ثم تعود إلى مقبرة السلطة السعيدة.
قبل ساعات من إطلاق سراحه، كتب شقيق إسلام خليل أنه حين استنجد بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، قالوا له إن كل ما يجري مع شقيقه من “اختفاء قسري .. تعذيب .. تلفيق قضايا واضح .. حبس احتياطي تعسفي .. تعذيب تاني وتالت ورابع .. حبس انفرادي .. تلفيق قضية تانية .. تعذيب بعد إخلاء سبيل .. حبس خارج إطار القانون بعد إخلاء السبيل .. كل دي إجراءات اعتيادية، وبتتعمل مع ناس كتير، وإحنا مش هنعمل حاجة غير إننا نصبر و خلاص”.
هنا، يتحول الصبر من فضيلة إلى عار، وفعل شائن، مثل الصمت الذي يخيم على الرموز الثورية التي بنت مجدها السياسي والنضالي من عوائد الاستثمار في فاجعة مقتل الشاب، خالد سعيد، قبل يناير/ كانون الثاني 2011، والذين صاروا يغرّدون، أو يدوّنون، إلا حين يتعلق الأمر بأسماء ذائعة الصيت، وهو الخيط الذي التقطته السلطة، وأصبحت تلعب عليه، من خلال قوائم العفو وإخلاء السبيل المطعمة بأسماء رنانة. وفي أثناء ذلك، تواصل إجراءاتها التوحشية بحق البسطاء والعامة من الناس.
المحزن في الأمر أن سماكة جلد الرموز الكبيرة انتقلت إلى الجماهير، إذ صار الخوف جداراً عازلاً بينها وبين مقاومة الظلم والانتفاض من أجل الكرامة الإنسانية، ولو كانت مصر هي مصر، لشاهدنا عشرات الآلاف من البشر في جنازة طالب الطب، شهيد مصر الذي قتلته السلطة، وشوّهت جثته، وسمعته، تماماً، مثل خالد سعيد، بادّعائها الكذوب أنه سقط من أعلى وكر للرذيلة. أنت بصدد لحظة يتحوّل فيها أعضاء ما يسمى “مجلس حقوق الإنسان” إلى شياطين خُرْسٍ، في أفضل التوصيفات، وتشاء المقادير أن يكون تصريحهم أنهم لا يملكون إلا “نصبر وخلاص” متزامنا مع الذكرى الأولى للزيارة التاريخية لوفد منهم، بقيادة حافظ أبو سعدة، إلى السجون ليعلنوا بعدها أن الخدمة فيها فندقية، وطعامها أشهى مما تقدّمه المطاعم الشهيرة.
كان من المتصور أن يقدم أعضاء المجلس الحقوقي على خطوةٍ، تمثل الحد الأدنى من احترام الذات، بأن يتقدّموا باستقالةٍ جماعيةٍ من هذا العار الذي يلفهم جميعا، أو أن يستقيل بعضهم، بشكل فردي، ويعلن العودة إلى صفوف الجماهير، ولو على سبيل ذرّ الرماد في العيون، أو القفز الاستباقي من سفينةٍ في طريقها إلى الغرق، كما فعل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مثلاً، غير أن شيئاً من ذلك لا يحدث، في ظل ارتفاع منسوب البطش والقتل المادي والمعنوي لمستويات مرعبة.
فكيف لمن كان أداةً لقتل روح الجماهير، وتم استعماله غطاء لقتل الناس في تجمعات الغضب ضد الانقلاب، أن يفكر في الاقتراب من الجماهير مجدداً؟ قبل رحيله، قال آخر الحقوقيين الكبار، أحمد سيف الإسلام، إن خطورة مذابح رابعة العدوية، وما سبقها وما تلاها، أن الهدف منها هو إنهاء عصر الجماهير، من خلال تنفيذ ما من شأنه تآكل وتضاؤل وزن الجماهير كقوة محركة في العمل السياسي، في المستقبل، وهو ما ستدفع ثمنه كل القوى السياسية، وليس فقط الإخوان، وهو ما تراه ماثلاً أمامك الآن.
كلهم، إلا ما ندر، اختاروا، الانعزال عن الجماهير، والخضوع والخنوع أمام جبروت سلطة تفعل بالمصريين ما هو أبشع مما صوره أمل دنقل، عن أمة الأعداء، في قصيدته “لا وقت للبكاء”، حين قال:
مجنونة الأنياب والرغبة..
تشرب من دماء أبنائك قربة..
قربة تفرش أطفالك فى الأرض بساطاً..
للمدرعات والأحذية الصلبة
وأنت تبكين على الأبناء،
تبكين؟